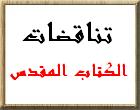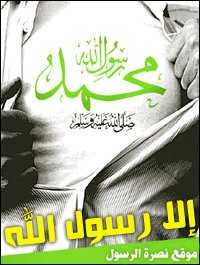ترشيد الثورة وتجديد الثروة

بقلم – أبى عبد الله الصارم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير خلْق الله أجمعين، وعلى آله وصَحبِه الأخيار الطاهرين، وبعدُ:
فإنَّ إنكار المسلمين على الأنظمة الظالمة الطاغية، وخُرُوجها على الحكومات غير الشرعيَّة – عملٌ ينبغي أنْ ينبثق من مُقرَّرات الشريعة، وينضَبِط بضوابط الشرع، وإلا أفضى إلى الفَوضَى والهرج وإراقة الدِّماء بغير مصلحةٍ راجحةٍ.
وحيث إنَّ الثورات التي اندَلعتْ في بعض بلاد المسلمين لم تصدُر عن مُنطلَق إسلامي في أصلها، ولم تتَّخِذ من العُلَماء وأهل الحلِّ والعقد مرجعًا وقائدًا لها، فإنَّه من الواجب على عُلَماء المسلمين ودُعاتهم العمل على ترشيد هذه الثورات وتصحيح مَسارها؛ حتى تُحقِّق المصالح الشرعيَّة، كما ينبَغِي عليهم حِمايتها من مَكايِد أعداء الدِّين الذين يعمَلُون على استِثمار مثْل هذه الأحداث لتَحقِيق مَآرِبهم في حرب الإسلام وأهله. ومن خِلال رؤيةٍ واقعيَّة يتَّضِح لنا أنَّ أهمَّ ما ينبغي أنْ تُرشَد إليه هذه الثورات ما يلي:
أولاً: ضرورة الابتِعاد عن الدعوات الجاهليَّة، والرايات العلمانيَّة التي تجعل من الوطن وثنًا يُقدَّس ترابُه ويُفدَى بالأرواح، ويكون معقدًا للولاء والبراء؛ ومن ثَمَّ يتمُّ تهميش دور الدين والتقليل من شأن الشريعة ومرجعيَّتها. فلا بُدَّ أنَّ يعلم الجميع أنَّ الجهاد لا يكون من أجل رفعة وطنٍ أو جنس أو شخص، وإنما الجهاد لغايةٍ واحدة وهي أنْ تكون كلمة الله هي العُليا. فعن أبي موسى الأشعري – رضِي الله عنه – قال: جاء رجلٌ إلى النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقال: الرجل يقاتل حميَّة ويقاتل شجاعة ويقاتل رياءً، فأيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله))[1].
ومعنى “يقاتل حميَّة” أي: لأجل عشيرته أو قبيلته أو صحبه. قال النووي في شرحه للحديث: “قوله: “ويقاتل حميَّة” هي: الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته، قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العُليَا فهو في سبيل الله))، فيه بيان أنَّ الأعمال إنما تُحسَب بالنيات الصالحة، وأنَّ الفضل الذي ورد في المجاهِدين في سبيل الله يختصُّ بِمَن قاتَل لتكون كلمة الله هي العُليا”[2].
ثانيًا: أنَّ إزالة المنكر إنْ كانت واجبةً من حيث الأصل، فإنَّه يُشتَرط لإزالة هذا المنكر ألاَّ يتسبَّب في وقوع منكرٍ أكبر، فإنْ تسبَّبَ أمرٌ بمعروف أو نهيٌ عن منكر في وقوع مَفسَدة راجحة، لم يكن هذا الأمر والنهي مشروعًا. ولذلك ترك النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – قتْل عبدالله بن أُبَيِّ بن سلول وغيره من أئمَّة الكفر والنفاق؛ مخافةَ نفور الناس منه إذا سمعوا أنَّه يقتُلُ أصحابه، وترك ردَّ الكعبة على قواعد إبراهيم؛ لحداثة عهد القوم بالكفر.
فعن عائشة – رضِي الله عنها – قالت: قال لي رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لولا حداثةُ عهد قومك بالكُفر لنقضت الكعبةَ ولجعلتُها على أساس إبراهيم))[3]. قال النووي: “وفي هذا الحديث دليلٌ لقواعد من الأحكام منها: إذا تعارَضت المصالح أو تعارَضت مصلحة ومفسدة وتعذَّر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأنَّ النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – أخبر أنَّ نقْض الكعبة وردَّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم – صلَّى الله عليه وسلَّم – مصلحة، ولكن تُعارِضه مفسدةٌ أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض مَن أسلم قريبًا؛ وذلك لما كانوا يعتَقِدونه من فضْل الكعبة، فيرَوْن تغييرها عظيمًا، فتركها – صلَّى الله عليه وسلَّم”[4].
وقال ابن تيميَّة: “فإنَّ الأمر والنهي وإنْ كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فيُنظَر في المعارض له، فإنْ كان يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته”[5].
وقال أيضًا: “فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته، لم يكن ممَّا أمر الله به، وإن كان قد تُرك واجبٌ، وفُعل محرَّم؛ إذ المؤمن عليه أنْ يتَّقي الله في عباد الله وليس عليه هُداهم”[6].
وعلى هذا فلا ينبغي أنْ تكون غاية تلك الثورات مجرَّد إسقاط حاكم أو حكومة غير شرعيَّة، بصرْف النظر عن عَواقِب ذلك، بل يجب العمل على أنْ يكون البديل – في أقلِّ الأحوال – أكثر عدلاً وأقرب إلى الشرع. فإنَّ أعداء الدِّين وأعوانهم قد يُسارِعون بانتِهاز الفرصة للانقِضاض على البلاد، أو العمل على تولية عميل لهم يكون أكثر خبثًا وأشد حربًا على الإسلام والمسلمين، أو ربما يعملون على نشر الفَوضَى وإذكاء الفتن وتهييج المسلمين للتناحُر والاقتتال بينهم؛ حتى يزيدوهم ضعفًا وانقسامًا وفشلاً، فتذهب ريحهم ويكونوا لقمة سائغة لأعدائهم.
ثالثًا: أنَّ اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة لا غير، وأمر تقديره موكولٌ لأهل الذكر من العلماء الربانيين العارِفين بشرع الله، المحيطين بفقه الواقع. ولذلك يجبُ أنْ يكون الناس تبعًا لهؤلاء العلماء؛ يهتدون بعلمهم ويُرشدون بفتواهم ويطيعون أمرهم؛ قال الله – تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].
وقد نقل أهل التفسير عن ابن عباسٍ ومجاهد والحسن وأبي العالية وعطاء وغيرهم أنَّ المقصود بـ{وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}: العلماء أهل الفقه والدِّين[7]. ومن هنا يُعلَم خطأ بعض العوامِّ الذين نصَّبوا أنفسهم حكمًا على العلماء؛ فإنْ أُعطوا من الفتاوى ما يوافق هواهم رضوا، وإنْ لم يجدوا ما يوافق هواهم قذفوا العلماء والدعاة بالتخاذل والتثبيط ونحو ذلك من تهم معلَّبة جاهزة.
وكذلك فإنَّ الذي يخضع من أهل العلم لضغوط الحماهير، فيُفتِي بما يُوافِق هواهم – وإنْ خالف معتقده – فهو خائنٌ لأمَّته، مضيِّع للأمانة، لا يقلُّ في شره عن علماء السلاطين. فالعالم الرباني هو الذي يُبلِّغ حكم الله وينطق بالحق، ولا يخافُ في الله لومة لائم، ولا يصدُّه اتهامات المرجفين وادِّعاءات الموتورين ولا استنكارات الجاهلين، يقول ما يُرضِي الجبار – سبحانه – ولا يُبالِي بعدها برضا السلاطين والشعوب أو سخطهم. وينبغي أنْ يعلم أنَّ علماء المسلمين لا قَداسة لهم في أشخاصهم وذواتهم، وإنما اكتسَبُوا مكانتهم العليَّة بما لديهم من علمٍ بالكتاب والسنة، يدلُّون الناس به على حكم الله – تعالى – ويبصِّرونهم بمراده – سبحانه – فإنْ خالفت أقوالهم أو أفعالهم نصوصَ الوحي صارت مردودةً عليهم ويجبُ الإعراض عنها.
رابعًا: أنَّ استخلاف الله الناسَ في الأرض منوطٌ بإقامتهم لدينه وتحكيمهم لشرعه، فينبغي أنْ يكون مطلب كلِّ مسلم أنْ يُحكَم بشريعة الله لا يَرضَى بغيرها بديلاً؛ قال الله – تعالى -: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : 65]. وقال – سبحانه -: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: 40].
وينبغي أنْ يُعلم أنَّ تنحية شريعة الله والاحتكام إلى الشرائع البشرية والقوانين الوضعية هي أكبر جريمة ارتُكِبت في حقِّ الأمَّة، وأنَّه لا نجاة لهذه الأمة ولا خلاص إلا بالعودة للإسلام وإقامة دين الله وتحكيم شرعه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يجوز أنْ يكون المسلم داعيًا لتحكيم شرائع جاهلية، مُعظِّمًا لقوانين بشرية مخالفة لحكم الله؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50].
ولذلك يجب أنْ نوضح للمفتونين بالديمقراطية[8] أنها نظام كفري علماني يقومُ في الأساس على أنَّ الحكم يكونُ للشعب لا لله، وأنَّ نوَّاب الشعب مخولون بتشريع القوانين التي تصبح دستورًا يجبُ احترامه، وإن خالَفَ نصوص القُرآن والسنَّة. وفي ظلِّ دعاوى التضليل لا عجب أنْ نرى كثيرًا من الجهَّال قد سقطوا في هوَس الديمقراطية؛ لظنِّهم أنها تُرادِف الشورى أو الحريَّة التي يُقرِّرها شرع الله. والحق أنَّ الإسلام حين يُقرِّر أصول العدالة والحريَّة، فإنَّه يقررها وفْق منهاج رباني لا يسمح بالتفلُّت من أحكام الشريعة، ولا يترك الناس أسرى لزبالات أفكار البشر تحكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وإنما يَضمَنُ للمؤمنين حياةَ العز والكرامة حين يُحرِّرهم من عبودية الأهواء والشهوات، ويجعلهم عبادًا لله – تعالى – وحده يستقيمون على أمره ولا يحكمهم إلا شرعه. خامسًا: أنَّ عقيدة الولاء والبراء من أصول الإيمان، والولاء لا يتحقَّق إلا بالمحبَّة الخالصة والنصرة الصادقة لكلِّ مَن نُوالِيه من المؤمنين، والبراء حقيقته بُغض وعداوة الكفر وأهله، وهذا من أوثق عُرَى الإيمان؛
قال الله – تعالى -: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 71]. وقال – سبحانه -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة: 51]. وقال – عزَّ وجلَّ -: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [الممتحنة: 4].
وعن ابن مسعود – رضِي الله عنه – قال: “دخَل عليَّ رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – فقال: ((يا ابن مسعود)) قلتُ: لبيك يا رسول الله – قالها ثلاثًا -: ((تدري أي عُرَى الإيمان أوثق؟)) قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ((فإنَّ أوثق عُرَى الإسلام الولاية فيه، الحب فيه والبغض))[9]. ومن ثَمَّ يظهر ضَلال الدعوة إلى الأخوَّة مع الكافرين والاتحاد معهم في نسيجٍ واحد، وإذابة الفوارق الدينية، فإنَّ التعاون مع الكافرين على إحقاق حقٍّ، أو إبطال باطل، أو دفع ظلم، أو فعل برٍّ – جائزٌ لا بأس فيه، لكنَّه لا يعني اختلاط الرايات وإلغاء الفوارق وعدم التمايُز.
بل يجب أنْ يتميَّز الموحدون عن غيرهم، وأنْ يحفظ أهلُ الإسلام هويَّتهم، ويعتزُّوا بها، وتظل عقيدة الولاء والبراء مشرقةً في نفوسهم، فإن اقتضت المصلحة الاستعانة بكافر اقتصرنا على قدر الحاجة دون العبث بالأصول العقديَّة. سادسًا: أنَّ ظُلم الحكام وطغيانهم لا ينبغي أنْ ينسينا ما يقع فيه كثيرٌ من أبناء شعوبنا المسلمة من ظلمٍ لأنفسهم، بعصيانهم لربهم، وانتهاكهم لِمَحارِمه، وتقصيرهم في واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فالحكَّام لا يصلحون مبررًا لكلِّ خطايا الشعوب، وظُلمهم وطغيانهم لا يُعَدُّ شهادة إبراء ذمَّة لكلِّ العاصين. فهل الحكام مثلاً هم المسؤولون وحدَهم عن الذين وضعوا أموالهم في بنوكٍ ربويَّة أو الذين أدمَنُوا استماع المعازف والغناء الفاسق ومشاهدة المواد الفاسدة على شاشة التلفاز، أو اللائي خرجن متبرجات كاسيات عاريات تحت سمْع وبصَر أوليائهن؟!
لا ريب أنَّ للحكام كِفلاً من ذلك وللشعوب كفلها أيضًا. ولذلك يجب أنْ يشتمل خِطاب الدعاة على التذكير بوجوب التوبة من تلك الذنوب والإسراع في الإنابة إلى الله، وليكنْ سقوط أولئك الطُّغاة عظةً وعبرة لنا جميعًا؛ لنعلم أنَّ العز كلَّ العز في طاعة الله والتذلُّل لعظمته والافتقار إلى رحمته. وأخيرًا: فقد كانت هذه الثورات كاشفةً لحقيقة الثروات التي تملكها هذه الأمَّة؛ حيث أبرزت الكثير من الخير الذي ما زال قائمًا في هذه الأمَّة متمثلاً في مواقف الصمود والثبات والشجاعة،
ومشاهد اللجوء إلى الله ودُعائه والاستعانة به، والتعاون على البِرِّ ودفع الظلم؛ ممَّا يُؤكِّد المعدن الطيب لهذه الشعوب المسلمة. فينبغي الاهتمام بإبراز هذه الجوانب الطيِّبة وتدعيمها والتشجيع عليها؛ لتكون نقطةَ انطلاقٍ لمزيدٍ من الخير. كما يجب الحرص على توظيف طاقات أبناء هذه الأمَّة وإرشادهم لما يستغلُّون فيه إمكاناتهم ويُظهِرون فيه حقيقة معدنهم الطيب، فإنهم ثروة أمَّتنا، ويجب العمل دومًا على إيقاظهم، وتفعيل دورهم، وتجديد النشاط في قلوبهم. نسأل الله أنْ ينوِّر بصائرنا،
وأنْ يرينا الحقَّ حقًّا ويرزقنا اتباعه، وأنْ يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وألاَّ يجعل مصيبتنا في دِيننا، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأنْ يستعملنا في خِدمة الدين، وأنْ ينصر عباده المستضعفين من الموحِّدين. وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على عبده ورسوله محمد خير الأنام، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان.
[1] أخرجه البخاري (6904)، ومسلم (3524). [2] شرح صحيح مسلم؛ للنووي. [3] أخرجه البخاري (123)، ومسلم (2367). [4] شرح صحيح مسلم؛ للنووي. [5] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص32. [6] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص24. [7] انظر: تفسير الطبري (5/206 – 207). [8] الديمقراطية في الأصل مصطلح يوناني مؤلف من لفظين: الأول (ديموس) ومعناه: الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه: حكم أو سيادة، فمعنى المصطلح مركبًا: سيادة الشعب، أو حكم الشعب. [9] الطبراني في الكبير (10531) وسنده حسن، انظر: السلسلة الصحيحة (1728).